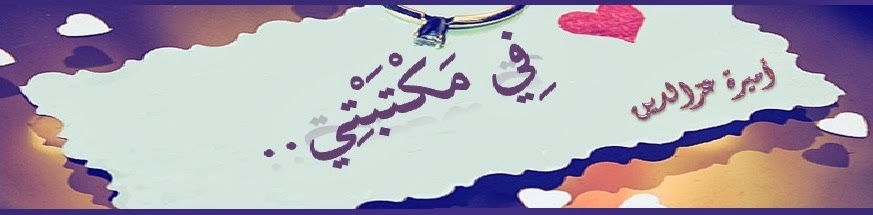"أنا
السؤال والجواب.. أنا مفتاح السر وحل اللغز، أنا بشر عامر عبد الـ .."
قفزت عبارة
يحيى الفخراني - التي اشتهر بها تتر مسلسل زيزنيا - إلى ذهني بمجرد انتهائي من
"ترنيمة سلام" لـ أحمد عبد المجيد، لكن بدون اسم: بشر عامر عبد الظاهر بالطبع!..
قدم لنا
(عبد المجيد) وجبة روحانية دسمة بداخل أحداث حياتية نعايشها في كل لحظة، ليؤكد لنا
أن السر دائما فينا لو بحثنا جيدا!
في العادة
يكون للعمل الروائي هدف رئيسي أو فلسفة ما، وأهداف أخرى فرعية تعكس آراء الكاتب في
التفاصيل، وعادةً ما تكون تلك الأهداف متوازنة ومتداخلة بما يرضى أكبر شريحة ممكنة
من القراء، فنجد الهدف القريب - وهو الحكاية - والتي يستمتع بها القارئ الذي يهوى الأحداث
الجديدة، ونجد جماليات السرد التي تخاطب القارئ الذي يقدر اللغة وفنياتها، وأخيرًا
نجد فلسفة العمل التي يلتقطها فقط القارئ الباحث عن قيمة جديدة مضافة مع كل سطر يقرأه.
كل تلك الأهداف تقدم متشابكة في تناغم، ولكل قارئ عينه الكاشفة للفائدة التي يريد.
في
"ترنيمة سلام" قدم لنا الكاتب كل ذلك ولكن في تتابع عوضًا عن التشابك، فمع
كل مشهد جديد يقوم بمخاطبة وعي أعمق، يحكي، ثم يعلو باللغة، ثم يأخذنا معه صاعدًا لمفتاح
السر، وكأنما يريد ألا يكمل معه رحلة الرواية سوى القارئ الباحث عن القيمة المضافة!
في بداية
الأحداث قد يتخيل القارئ أن الكاتب وضعه أمام عدة أبطال لعدة حكايات هناك رابط ما بينهم
جميعًا، فيقف مفكرًا للحظات متسائلاً أيهم بطل العمل الحقيقي؟! هل هو المسافر (خالد
عبد الدايم)، أم الرجل المسن (خالد محمد)، أم الكاتب المعروف (خالد محفوظ)؟!.. ومع
متابعة القراءة نكتشف أن التعدد ليس فعليًا والحكايات لم تتطرق بعيدًا من الأساس وأنها
حكاية متصلة حدثت وتحدث باستمرار، وأن لكل (خالد) فيهم موقعًا نمر عليه جميعًا في حياتنا!
اختيار اسم
(خالد) موفق جدًا من الكاتب، فالمعنى الذي يتعرض له خالد في أذهان كل البشر، والسؤال
الذي طرحه علينا في بداية العمل على لسان (خالد) الفتى الصغير: "كيف يمكن للإنسان
أن يحافظ على سلامه النفسي دائمًا؟" هو سؤال أزلي ربما يتردد يوميًا في أذهاننا
دون أن نشعر وبطرق مختلفة أبسطها حين نتساءل: "يارب امتى أرتاح بقى؟!"
وعلق لنا
الكاتب تحديًا واضحًا حين أعطانا طرف الخيط في المشاهد الأولى في تساؤل ذلك الفتى،
إلا أن القارئ لن يتمكن من الإجابة على ذلك السؤال حتى ولو حاول ببعض إجابات كلها لن
تكون سوى جزء من الإجابة الصحيحة وليست كاملة!
استخدم الكاتب
- في بداية تعريفنا بشخصية (خالد) – أسلوب التداعيات الفكرية لكي يعكس لنا سوداوية
الشخصية بشكل واضح، فنحن جميعًا حين نفكر في همومنا تتداعى أفكارنا للأسوأ ونجلس مصابين
بشلل الإرادة نتخيل الوقائع ونتخيل ردود أفعالنا التي لن نستطيع إتيانها في الحقيقة
كنوع من رد الفعل النفسي المضاد لمخاوفنا .
واستمر الكاتب
يعلو بالحدث ويخرج بـ (خالد) من فشل تلو الآخر لدرجة نندهش معها من كل هذا الكمّ من
السقطات في حياته، لكن (خالد) كان كمن يستدعي بطاقته السلبية كل الفشل من حوله حتى
إن ذلك انعكس على موضوعات قصصه، فكتب عن النفس البشرية بشكل سودوي للغاية لمجرد أن
يثبت لنفسه أنه إنسان سوي!
لكنه – ومع
آخر نقاط فشله التي وصل معها إلى أنه لم يعد يمتلك ما يخشى عليه، ولم تعد به الرغبة
حتى في استدرار عطف الآخرين – تحول ليكون إنسانًا إيجابيًا دون أن يشعر، فخسارته لكل
شيء منحته القدرة الخفية على الإتيان بأفعال كان يخشاها لكي لا يفقد العطف ممن حوله.
وبدأ عند تلك النقطة في استعادة نفسه شيئًا فشيئًا، وكأنما نحن نستدعي أقدارنا، فقد
وقعت في يده لحظتها "الحكم العطائية" - التي خطها الإمام (ابن عطاء الله)
حقًا لكنها وردت في الرواية بتفسير خطه الكاتب - ليجد نفسه يقرأ ما فعله تحت مؤشرات
الإرادة الحقيقية، وكأنما قدره كان ينتظر منه لمحة إيجابية تضعه على بداية تصالحه مع
الحياة ومع نفسه!
ومن أهم ما
تقرأه في الحكم العطائية أن الحب هو الفطرة الأولى وما دونه زيف، فلو حاولونا التمسك
بتلك الفطرة - رغم كل الطاقات السلبية الكريهة - سنتمكن من استدعاء الخير المقدر لنا،
بالطبع لن نبدل أقدارنا ولكن بنظرة إيمانية بسيطة نجد أن خلف كل واقعة تعيسة خير لا
ندركه ونعلم أن القدر هو الخير في النهاية، ولكنَّا حين نقوم بالاختيارات الخاطئة قد
تقع لنا الأمور التعيسة التي تحزننا، فتعالوا نتخيل لو أصررنا على استقبال الطاقة الخيرة
فقط ممن حولنا موقنين أن الخير فيما لا ندركه عند الله، وقتها سنصل لخير أقدارنا بالطرق
الأقصر والأكثر مباشرة دون حوادث تعيسة تؤلمنا!
في اعتقادي
هذا ما أراد الكاتب أن يوصله لنا، فبالطبع لم يكن هدفه أن نتصور أولياء الله الصالحين
وهم يبدلون الأقدار وفقًا لرغباتهم، لكنهم في الحقيقة أُناس آمنوا بخير القدر ووثقوا
في الإرادة الإلهية فكانت اختياراتهم الحياتية موائمة للقدر المكتوب لهم وليس العكس.
إن أردت أن
أنقل لكم وصفا عن لغة الرواية وسردها فكفى بي أن أذكركم بتلك الأبيات للحسين بن المنصور
(الحلاج) لتتصوروا ما قد تعيشونه مع الحدث وما قد تحمله لكم لغة الكاتب:
والله ما
طلعت شمسٌ ولا غرُبت إلا و حبّـك مقـرونٌ بأنفاسـي
ولا خلوتُ
إلى قومٍ أحدّثهــم إلا وأنت حديثي بين جُلاســي
ولا ذكرتُك
محزونًا و لا فَرِحًا إلا و أنت بقلبي بين وسواســـي
ولا هممتُ
بشربِ الماء من عطشٍ إلا رَأَيْتُ خيالًا منك في الكـــأسِ
وبعد رحلة
رائعة، تركت دائمًا عينيّ دامعة - تمامًا كما تفعل بي أبيات الحلاج - أتحدى أي قارئ
ألا تنتقل إليه موجتها الإيجابية، أتحداه ألا يشعر بطاقة حب هائلة قد لا يتمكن من شرحها
حتى لنفسه وهي تتسرب منه إلى كل شيء وكل شخص حوله!..
عزيزي القارئ
ستحب حتى أخطاءك السابقة وما لحقها من ألم، لكنك لن تندم عليها لأنها جعلتك على ما
أنت عليه الآن إن كنت راضٍ عن قدرك، وإن كنت من هؤلاء التعساء ملقيي اللوم على الحظ
العثر دائمًا أعدك أن تقف مفكرًا "ما الذي تفعله بنفسك أنت وليس الحظ!"
أعزائي، حاولوا
أن تتعلموا كيف تحافظوا على تلك الترنيمة المسالمة التي ستغزو وجدانكم مع آخر سطور
العمل، حاولوا كما فعل (خالد) بعد سماعه لقصة (خالد) التي رواها له الشيخ (خالد) لأنه
عرف فيها نفسه ومدى ما قد تحققه له إرادته من سلام داخلي!