
(1)
"من يخالطه يجده كالنهر الذي يمنحك الغذاء أو يرويك بفيضه وفى أقل الأحوال تسر بمرآه، فله أياد بيضاء على الكثير من المثقفين وعلى الحركة الثقافية في مصر، فهو جلد صبور لا يعرف اليأس، ويتجلى ذلك في ورشته أي ’’ورشة الزيتون‘‘ بمقر حزب التجمع التي صارت كعبة للمثقفين من كافة الأصقاع، ولئن وشى هذا المسلك بشيء فأول ما يشي به هو الثبات والرسوخ على المبدأ."
تلك كانت كلمات الأديبة أ. (سامية أبو زيد) عن الشاعر الكبير أ. (شعبان يوسف)، فقد وجدتني لا أستطيع إلا أن أستعين بنعتها الدقيق لشخصه وصفاته، ذلك الأستاذ والمناضل الثقافي الباحث دائماً- وعلى مدار ربع القرن- عن نبتة الخير في أقلام الشباب أمثالنا.
حين تصفحت "أحلام شكسبيرية" للأستاذ (شعبان يوسف)، وجدته يصحبني في عالم كلاسيكي حالم وفي ذات الوقت مغرق في هموم الواقع!
فـ "شكسبير" بكل كلاسيكيته وشخوصه الحالمة الرومانسية لم يستطع أن يطغى على الروح الشرقية للشاعر، فكانت فقط مجرد ألوان ريشات تتناسب ورسمه للمعاني.
اختار أرق شخوص "شكسبير" ليصورها كالوطن!.."أوفيليا"، شعرت بها وطناً يود المرء لو يهبها كل شيء فتكون علياؤها أقصى أمنياته، لكنها أمنيات تتكسر وسط المستأثرين بالوطن منّا.. فيقول في (من أجل أوفيليا):
ويتركها- هكذا- بين تلك الحشود العتيدة
يرقبها.. هادئا.. هادئا
من مكان قريب منزلها
تتسامق عالية مثل مأذنة ترتقي للعلا
ولكنها لا تنام.
بينما يقول في (طرف من اعترافات هاملت):
لماذا كولوديوس يقتل النبيل؟
ويخطف ألفته الدافئة؟
وكيف يكون بولونيوس
والد هذا الجمال؟
وكيف أنا سأصير إلى مأتمٍ معتمٍ هكذا؟
إذن سوف أعلن يا أصدقائي الكرام:
إنني لم أكن قائدا ماهرا لحياتي
التي ذهبت،
وحياتي التي ستجيء.
فقط...
كنت أحرس بعض حقول من العشب
والعدل،
والبرتقال...
"هاملت" هنا لا يشكو الخيانة والقبح، "هاملت" هنا هو المثالي الحالم.. قليل الحيلة- كعادة اكتسبها من الغدر الواقع عليه لسنوات. يعترف أنه لا يقوى على أن يكون القائد المناسب للوطن- في كلماتٍ تذكيرية باتهام (ناصر) بالوقوع في خطيئة الرومانسية الثورية- وأنه ليس سوى حارس خارج أسوار عدل الشعوب.
ويعود "هاملت" فيعترف بذنب في حق ضحية- وإن تملص من اقترافه:
وأعود..
وأوقف تلك الشهيدة
تحت مصابيح أسئلتي
وأعلنها:
أنني لم أكن قاتلا
بل قتيلا،
ولم أقترف- تحت هذي السماء النبيلة-
أي جرائم،
لم أكن شاهداً.. بل شهيدا...
وحين يواجهنا أ। (شعبان) برؤياه للحلم، نجد الأرض الطيبة محدثة ماهرة صبورة وشامخة رغم الجسد المثخن بجراح الطمع والاستنزاف. تشكو اللئام في هدوء متقبلة لأفاعيل القدر، ساخرة من الإنسان الحيوان الذي يعيش فقط لهثاً خلف أطماعه كحال الساسة الناهبين. فيقول في (أحلام شكسبيرية):
إنني يا صديقي البعيد
الذي يتهدج في الهاتف المعدني..
سئمت الذين يحطون أنفسهم في مواجهتي..
يرغبون في التواصل،
دون اكتشاف لروحي
ودون اختبارٍ لمعرفة القدر المتربص دوماً
أنا يا صديقي، أعيش الحياة بقوة،
وأسأل(ما الإنسان؟ إذا كان همه وانتفاعه بحياته أن ينام ويأكل؟..
حيوان لا أكثر!)
وفي استخدام أ. (شعبان) للفظ "يرغبون في التواصل" ما ذكرني بجمل برامج المحادثة الشهيرة، كأبلغ تدليل على أن مقاعد السلطة- دائماً وحتى عصورنا الحديثة والإلكترونية- قد تحمل من لا يعرف معنى للأرض الموكل عليها وإن كان يتودد في رغبة زائفة للتواصل الطامع.
ولا يزال الشعور يداخلني عن اتصال كل قصائد الديوان كوحدة روحية واحدة، تجعل اختلاف العناوين مجرد فواصل لالتقاط أنفاسنا ليس إلا.
فـ "أوفيليا" تعود لحالة من رثاء الذات كأنما وصلنا لنقطة هذيانها لدى "شكسبير" لكنها تهذى بالحق حين يقول أ.(شعبان) على لسانها في (صعود أوفيليا):
لا بديل..
سوى أن أعود لنفسي وأسألها:
أي عاصفة تنتظرني؟
وأي اغتراب سيقتلعني من جذوري؟
وأي خرابٍ يعشش في قمة العرش؟
وهل أن تلك البلاد بلادي؟
وهل هؤلاء الذين يحيطون بي...
يصيرون أهلي؟
وكاستسلام للحال تتقوقع "أوفيليا" على ذاتها في حجرة روحها مثلنا جميعاً على الطريقة "النعامية" في الهروب بين حبيبات الرمال، فتقول بحروف أ. (شعبان):
لا بديل،
سوى أن أرتب حجرة روحي،
وأسكنها،
لن أغادرها أبداً
سوف أدعو الرفاق إليها
وأجلسهم واحداً واحداً
ثم أسمعهم آيتي
- ما آيتي؟-
ويتابع بعدها مفسراً ما تلك الآية قائلاً:
آيتي أن أفك طلاسم تلك الرموز
التي رافقتني- طوال حياتي- وفرَّت،
بعد أن طعنت فطعنتي طعنة غادرة
وتهاوت تماماً
ورغم ذلك "أوفيليا" الشعبية ستبقى منعزلة في حجرة روحها "النعامية" الجدران رغم الخراب فوق العروش والطعنات الغادرة، وتبقى فقط تتأمل!.. إلى متى يا ترى؟
الحق أنني لست بمتخصصة أبداً ولكني فقط قارئة سجلتُ ما وقر في نفسي من معانٍ بين ضفتي الديوان، فتابعوا معي الحلقات القادمة للغوص أكثر في "الأحلام الشكسبيرية".
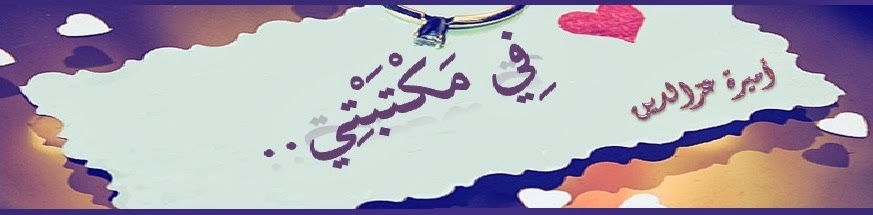
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق